ها قد مضى أزيَدُ من ساعة وأنا جالس قُبالة شاشة الحاسوب - عقارب السّاعة المُعلّقة على الحائط تخطّت الثالثة فجرًا، ولم أفلح بعدُ في تنضيد حرف واحد على شاشة حاسوبي - ألعَنُ الوقت الّذي يمضي سريعًا، أحارب النُّعاس والتعب.. ولكنّي مصرّ على ألّا تغمض لي عين، وألّا أرمي بجسديَ المُنهك على السرير، قبل أن أكتب عن "ساغ سليم"!
دخلت، يوم الجمُعة الأخير، قاعة "كريچر" في الكرمل الفرنسيّ الحيفاويّ، لحضور عرض "ساغ سليم"، للفنّان سليم ضوّ؛ لأجد نفسي - وبعد دقائق معدودة من بدء العرض - داخل بيت يشبه - إلى حدّ بعيد - بيت كلّ واحد منّا؛ بشكل أو بآخر، بحكاية أو بأخرى؛ دخلت بيتًا فِلَسطينيًّا قديمًا حميميًّا دافئًا. فلم يكتفِ سليم ضوّ بفتح أبواب القاعة لاستقبال الحضور، بل دفعته جرأته إلى أن يفتح - بل يُشرِع - باب بيته لاستقبالنا جميعًا.
في عرض "ساغ سليم"، استطاع الفنّان المُبدع أن يحوّل سيرته الذاتيّة الخاصّة إلى سيرة عامّة (سيرة على كلّ لسان - بالمفهوم الإيجابيّ)؛ ليكشف لنا أدقّ تفاصيله الشخصيّة من خلال عمل فنّي إبداعيّ - لا شكّ في ذلك - حاكى من خلاله كلّ واحد منّا.
ضحكَ فضحكتُ، بكى فبكَيتُ.. كنت مستسلمًا لهذا السليم، "أتأرجح" وأنتقل معه من حالة إلى أخرى؛ كان صادقًا إلى أبعد الحدود على المسرح، وصدقه هذا أرغمني على التضامن والتعاطف معه وأن أعيش حالته، فكنت أفرح لفرحه وأغضب لغضبه وأضحك لضحكه وأبكي لبكائه، أشاركه الحالة، فكيف لا وقد أدخلني بيته؟!
على مدار ساعتين تقريبًا، كان يروي لنا سليم ضوّ "حكاياه" الذاتيّة فكنّا نرتوي، وكلّما زاد ارتواؤنا عَطِشنا إلى المزيد. تسمّرنا في مقاعدنا - مُغرَمين لا مُرغَمين - مشدوهين مبهورين بقدرات هذا الفنّان العملاق، الّذي سيطر على المسرح وعلينا سيطرةً تامّة، أطاعه المسرح مُرغَمًا وصَغُر أمامه، ونحن أطعناه مُغرَمين.
نقل إليّ سليم تجربته الغنيّة - حياتيًّا وفنّيًّا - من خلال خشبة المسرح، ليثبت - مجدّدًا - أنّه ليس مجرّد فنّان أو نجم عابر في فلك النجوم، بل هو نجم يلمع ولا يمكن لوهجه أن يخبو طالما هو يقدّم لنا الأفضل، ليبقى مُشعًّا متلألئًا.
ما بين التراجيديّ والكوميديّ، ما بين الحزن والفرح، ما بين الجِدّ واللّعب، وما بين الراحة والتعب، ومزيج الحالات والتناقضات، برز صدق سليم الّذي لم يتغيّر بتغيّر الحالات!
عمل جبّار سليم حوى حالات إنسانيّة، وحكاني بكلّ صدق وشفافيّة.
حوى هذا العرض - رغم عدم اكتمال عناصر المسرح فيه؛ من ديكور وغيره - عدّة حالات مسرحيّة وفنيّة معًا، وقد استطاع سليم بكلّ بساطة، ومن دون أن يألُوَ جهدًا، أن "يأرجحني" وينقلني بخفّة من حالة إلى أخرى، من وضعيّة إلى وضعيّة، لأستسلم لهذا السليم الذي يدرك ما يفعل ويُبدع في إتقانه.
عمل رهيب جبّار، عمل غنّي راقٍ مميّز، خاصّ ومغاير؛ فقلّما نجد عملًا فنّيًّا متكاملًا على شاكلته على مسارحنا؛ وأنا لم أجد في هذا العمل إلّا الـ"ساغ" والسليم..
علّني استطعت بمقالتي المتواضعة هذه أن أفي عرض "ساغ سليم" حقّه، وإن لم يكُن مقالي هذا "ساغ" (سائغًا)، فعلى الأقل حاولت أن يكون "سليم" (سليمًا)، فليس كلّ واحد منّا يمكنه أن يقدّم عملًا "ساغ سليم".
تركت القاعة والابتسامة تعلو وجهي، والدمعة تترقرق في عينيّ، وصوت من داخلي يقول: رهيب، رهيب، رهيب..!
ها قد مضى أزيَدُ من ساعة وأنا جالس قُبالة شاشة الحاسوب - عقارب السّاعة المُعلّقة على الحائط تخطّت الثالثة فجرًا، ولم أفلح بعدُ في تنضيد حرف واحد على شاشة حاسوبي - ألعَنُ الوقت الّذي يمضي سريعًا، أحارب النُّعاس والتعب.. ولكنّي مصرّ على ألّا تغمض لي عين، وألّا أرمي بجسديَ المُنهك على السرير، قبل أن أكتب عن "ساغ سليم"!
دخلت، يوم الجمُعة الأخير، قاعة "كريچر" في الكرمل الفرنسيّ الحيفاويّ، لحضور عرض "ساغ سليم"، للفنّان سليم ضوّ؛ لأجد نفسي - وبعد دقائق معدودة من بدء العرض - داخل بيت يشبه - إلى حدّ بعيد - بيت كلّ واحد منّا؛ بشكل أو بآخر، بحكاية أو بأخرى؛ دخلت بيتًا فِلَسطينيًّا قديمًا حميميًّا دافئًا. فلم يكتفِ سليم ضوّ بفتح أبواب القاعة لاستقبال الحضور، بل دفعته جرأته إلى أن يفتح - بل يُشرِع - باب بيته لاستقبالنا جميعًا.
في عرض "ساغ سليم"، استطاع الفنّان المُبدع أن يحوّل سيرته الذاتيّة الخاصّة إلى سيرة عامّة (سيرة على كلّ لسان - بالمفهوم الإيجابيّ)؛ ليكشف لنا أدقّ تفاصيله الشخصيّة من خلال عمل فنّي إبداعيّ - لا شكّ في ذلك - حاكى من خلاله كلّ واحد منّا.
ضحكَ فضحكتُ، بكى فبكَيتُ.. كنت مستسلمًا لهذا السليم، "أتأرجح" وأنتقل معه من حالة إلى أخرى؛ كان صادقًا إلى أبعد الحدود على المسرح، وصدقه هذا أرغمني على التضامن والتعاطف معه وأن أعيش حالته، فكنت أفرح لفرحه وأغضب لغضبه وأضحك لضحكه وأبكي لبكائه، أشاركه الحالة، فكيف لا وقد أدخلني بيته؟!
على مدار ساعتين تقريبًا، كان يروي لنا سليم ضوّ "حكاياه" الذاتيّة فكنّا نرتوي، وكلّما زاد ارتواؤنا عَطِشنا إلى المزيد. تسمّرنا في مقاعدنا - مُغرَمين لا مُرغَمين - مشدوهين مبهورين بقدرات هذا الفنّان العملاق، الّذي سيطر على المسرح وعلينا سيطرةً تامّة، أطاعه المسرح مُرغَمًا وصَغُر أمامه، ونحن أطعناه مُغرَمين.
نقل إليّ سليم تجربته الغنيّة - حياتيًّا وفنّيًّا - من خلال خشبة المسرح، ليثبت - مجدّدًا - أنّه ليس مجرّد فنّان أو نجم عابر في فلك النجوم، بل هو نجم يلمع ولا يمكن لوهجه أن يخبو طالما هو يقدّم لنا الأفضل، ليبقى مُشعًّا متلألئًا.
ما بين التراجيديّ والكوميديّ، ما بين الحزن والفرح، ما بين الجِدّ واللّعب، وما بين الراحة والتعب، ومزيج الحالات والتناقضات، برز صدق سليم الّذي لم يتغيّر بتغيّر الحالات!
عمل جبّار سليم حوى حالات إنسانيّة، وحكاني بكلّ صدق وشفافيّة.
حوى هذا العرض - رغم عدم اكتمال عناصر المسرح فيه؛ من ديكور وغيره - عدّة حالات مسرحيّة وفنيّة معًا، وقد استطاع سليم بكلّ بساطة، ومن دون أن يألُوَ جهدًا، أن "يأرجحني" وينقلني بخفّة من حالة إلى أخرى، من وضعيّة إلى وضعيّة، لأستسلم لهذا السليم الذي يدرك ما يفعل ويُبدع في إتقانه.
عمل رهيب جبّار، عمل غنّي راقٍ مميّز، خاصّ ومغاير؛ فقلّما نجد عملًا فنّيًّا متكاملًا على شاكلته على مسارحنا؛ وأنا لم أجد في هذا العمل إلّا الـ"ساغ" والسليم..
علّني استطعت بمقالتي المتواضعة هذه أن أفي عرض "ساغ سليم" حقّه، وإن لم يكُن مقالي هذا "ساغ" (سائغًا)، فعلى الأقل حاولت أن يكون "سليم" (سليمًا)، فليس كلّ واحد منّا يمكنه أن يقدّم عملًا "ساغ سليم".
تركت القاعة والابتسامة تعلو وجهي، والدمعة تترقرق في عينيّ، وصوت من داخلي يقول: رهيب، رهيب، رهيب..!
يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!



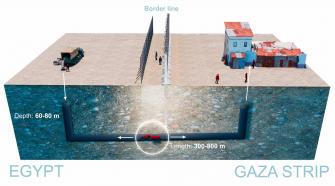





التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.