بعد جفاء ميّز العلاقات الأميركية الفلسطينية منذ تولي دونالد ترامب سدة الرئاسة الأميركية، وتجلّى بتجاهل الرسائل الفلسطينية، واقتصار الاتصالات على الموضوع الأمني، والتعهد بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، واعتبار الاستيطان لا يشكل عقبة أمام السلام، وفتح الطريق أمام خيارات أخرى بديلة عن حل الدولتين، ووقف تحويل الدعم الأميركي للسلطة الفلسطينية؛ حدث تحوّل مفاجئ، إذ أصبحت هناك مطالبة أميركية بكبح قليل للاستيطان، واتصل ترامب هاتفيًا بالرئيس محمود عباس ودعاه لزيارة البيت الأبيض، كما أُجّل موضوع نقل السفارة، واعتُمد عباس باعتباره شريكًا.
ردة الفعل الفلسطينية الرسمية بالغت كثيرًا، وكأنها مثل "الغريق الذي يتعلق بقشة"، واعتبرت أنّ هذا التغيّر الترامبي يفتح الطريق لاستئناف المفاوضات وإحياء ما يسمى "عملية السلام"، التي دخلت في غرفة العناية المكثفة منذ فترة طويلة ويتم إنعشاها لتبقى على قيد الحياة بين فترة وأخرى، من خلال تحرك سياسي أو مبادرة تُوظّف لتقطيع الوقت والتغطية على ما تقوم به إسرائيل، ويتم التعلق بأذيالها، في حين أنها تقطع الطريق على تبني الفلسطينيين والعرب خيارات وبدائل أخرى.
هكذا كان الأمر منذ انعقاد "مؤتمر مدريد" في العام 1991 وحتى الآن، فكل مبادرة جديدة تؤدي لإبقاء الوهم بأن تنجح في تحقيق ما عجزت عنه سابقاتها.
المطلوب أخذ العبرة مما جرى، ومن الكارثة التي يعيشها الفلسطينيون جراء اعتماد سياسة الرهان على ما يسمى عملية سلام، وتظهر معالمها بضياع القدس والمزيد من الأرض والحقوق، وتهميش القضية، وتآكل المؤسسات الفلسطينية، والشرذمة التي تتعمق وتتعمم، إلى جانب توهان القيادة الفلسطينية وانتقالها أكثر وأكثر لإعطاء الأولوية للنظام (السلطة) وبقائه، والحفاظ على شرعيته على حساب القضية والمشروع الوطني. ولعل أكبر دليل على ذلك ما جرى من قمع لتظاهرة تدافع عن حق الشهيد باسل الأعرج وزملائه المعتقلين في سجون الاحتلال بالتعامل معهم بكرامه تليق بما قدموه لوطنهم وشعبهم.
السؤال الذي يطرح نفسه ويجدر إمعان التفكير في الإجابة عنه بصورة صحيحة: لماذا غيّرت إدارة ترامب موقفها من السلطة وطريقة التعامل معها، وهل هذا يرجع إلى أنها عادت إلى "جادة الصواب"، أم لأنها ترى من جهة أولى أن تجاوز السلطة يمكن أن يؤدي الى الفوضى، وتصاعد القوى والاتجاهات المعادية لإسرائيل، والتي ستلتقي رغم خلافاتها على مقاومة الاحتلال الإسرائيلي؟
في ظل الخشية من احتمال تطور هذا السيناريو، ليس من المستبعد أن يكون نتنياهو والأجهزة الأمنية الإسرائيلية قد قدما نصيحة للإدارة الأميركية بشأن أهمية اعتماد السلطة كشريك (هناك في الحكومة الإسرائيلية وخارجها من لا يعترفون بالسلطة) لأنها من خلال التنسيق الأمني وتجنب المواجهه تخدم المصلحة الإسرائيلية، رغم بعض المنغصات المترتبة على ترددها في تقديم تنازلات جديدة تُلِّح عليها إسرائيل. وما يعزز هذا الاحتمال أن البدائل عن السلطة غير مضمونة وليست مؤكدة.
ومن جهة ثانية، اختارت إدارة البيت الأبيض أن من الأفضل أن تجرب أولا السعي لإنجاز "الصفقة الكبرى" التي يتحدث عنها ترامب من خلال "جس نبض" السلطة، على أمل أن تكون الآن مطواعة أكثر للاستجابة للشروط الإسرائيلية التي أصبحت إلى حد كبير هي الشروط الأميركية، لاسيما بعد الإشارات الإيجابية التي أرسلتها السلطة ومفادها أنها ستأخذ المخاوف والمطالب الأميركية بالحسبان؟
ويمكن تلخيص هذه الشروط باستئناف المفاوضات الثنائية دون تدخل من أحد وبلا شروط، ما يعني ضرورة تخلي الجانب الفلسطيني عن الشروط التي تحدث عنها خلال السنوات القليلة الماضية، وتشمل مرجعية واضحه وملزمة لأي مفاوضات قادمة، ووقف الاستيطان، وإطلاق الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل "أوسلو"، ورعاية دولية حقيقية للمفاوضات، إضافة إلى سقف زمني للتفاوض، وآخر لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
الملاحظ في الآونة الأخيرة أننا لم نعد نسمع كثيرا عن هذه الشروط (المتطلبات) لاستئناف المفاوضات. ما يعني أن القيادة الفلسطينية تعتبر أن الاعتراف بها قمة المنى، وأن السير وراء عملية سياسية أخرى، ولو كانت عملية بلا سلام كما نصح دنيس روس منذ وقت طويل، يعطيها سببا للبقاء رغم إدراكها - كما هو حال الجميع - بأن ما سيجري، في أحسن الأحوال، هو تكرار نفس الاسطوانة المشروخة التي استمعنا لها مرارًا، ولكنها ستُعزف هذه المرة بشكل أسوأ، وضمن سقف أقل، ونهايتها إذا نجحت ستكون أكثر كارثية؛ أي الاعتراف بإسرائيل باعتبارها "دولة يهودية"، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية من النهر إلى البحر، عدا عن التفاوض على حدود الدولة ناقصة السيادة من دون حل لقضية اللاجئين، ومن دون القدس، أو القبول بالحلول الجزئية والانتقالية التي تؤجل الحل النهائي وتعيد إنتاج أوسلو جديد بشروط أسوأ، مع فتح مزيد من الأبواب العربية أمام التطبيع المعلن.
يمكن أن يقول قائل: لن تقبل القيادة الفلسطينية بهذا الحل التصفوي، وهذا أمر وارد، مع أن إمكانياتها على الرفض ستكون أقل مما هي عليه الآن، لأن الأوضاع الفلسطينية ستكون أسوأ داخليًا وخارجيًا، وسيسهل تجاوزها وعزلها، خاصة أن الحديث عن المفاوضات الثنائية هذه المرة يترافق مع تقدم "الضم الزاحف" والتهديد بتحويله إلى "ضم قانوني"، ومع الحديث عن الحل الإقليمي، لأن إسرائيل تريد أن تقبض من العرب أولًا، كما تريد أن توظفهم للضغط على الفلسطينيين حتى يقبلوا ما يرفضون قبوله من دون العرب.
في المقابل، كان يمكن استثمار هذا الوقت الثمين لمراجعة التجربة، واستخلاص الدروس والعبر، وتغيير المسار، وإعادة تعريف المشروع الوطني، وإبقاء القضية حية، وتعزيز الصمود والتواجد البشري الفلسطيني على أرض الوطن، إضافة إلى توفير متطلبات مقاومة الاحتلال ومقاطعته بصورة مثمرة، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة على أساس القواسم المشتركة والشراكة الحقيقية، بما يجعل المنظمة قولا وفعلا الممثل الشرعي الوحيد والمؤسسة الوطنية الجامعة، وبما يمكنها من التعامل مع المخاطر الجديدة، والمتمثلة بشكل خاص بسعي إسرائيل لتصفية القضية وضم الضفة، ومن موقع أفضل بكثير.
إذا كان الهدف هو بقاء السلطة وشرعية قيادتها، فإن هذا الهدف قد يتحقق عبر مواصلة سياسة الانتظار والرهان على المفاوضات، رغم أن مصدر الشرعية الأهم هو إرادة الشعب. أما إذا كان الهدف إنهاء الاحتلال، فإنه لن يتحقق عن طريق المفاوضات الثنائية المباشرة أو غير المباشرة بدون قوة ووحدة ومؤسسات وطنية جامعة وسياسة فعالة، مع العلم أن الوضع لن يبقى على ما هو عليه، بل سيزداد سوءا، سواء قبلت القيادة تحقيق "الصفقة الكبرى" التي يحلم بها ترامب، أم رفضتها.



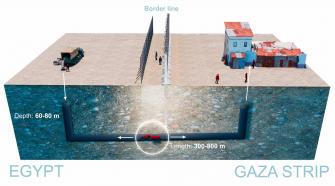





التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.